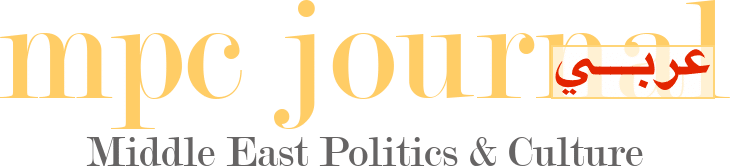بالنظر إلى سيناريو الشرق الأوسط الحالي، يمكن للمرء أن يقبل منطقياً بالراوية القائلة إن الاضطرابات الجارية في الشرق الأوسط يتحمل مسؤوليتها على قدم المساواة السياسات الأنجلو أمريكية الميكيافيلية في المنطقة والفشل المروع للحكومات الإسلامية / قيادات الشرق الأوسط في اللرد العقلاني على هذه التحديات.
التحالف الأنجلو أمريكي
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الداعم لبوش الأصغر في غزوه غير المبرر ضد العراق قال ذات مرة: “لقد حاولنا التدخل ووضع قوات على الأرض في العراق. حاولنا التدخل دون وضع قوات في ليبيا. ولم نحاول أي تدخل على الإطلاق لكن تمت المطالبة بتغيير النظام في سوريا. ليس من الواضح بالنسبة لي إن كانت سياستنا لم تنجح، أو أن السياسات اللاحقة قد عملت بشكل أفضل “.
اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كوندوليزا رايس في يونيو 2005 في خطاب ألقته في الجامعة الأمريكية في القاهرة حين قالت: “على مدار 60 عاما، بلدي، الولايات المتحدة، عمل لتحقيق الاستقرار على حساب الديمقراطية في هذه المنطقة هنا في الشرق الأوسط، ولم نحقق أيا منهما “. والنتيجة هي أن الديناميكية السياسية في منطقة الشرق الأوسط أصبحت المنافسة” بين الديكتاتوريات القمعية وجماعات المعارضة غير ليبرالية “.
ويبدو أن إدارة أوباما أخيرا، وبعد طول انتظار بدأت تفهم أن المعركة ضد التطرف الديني في الشرق الأوسط ستكون طويلة، وأنها نضال شاق. في الوقت الراهن، لن يكون هناك تدخل عسكري أمريكي على الأرض. لكنها ستكون حملة صعبة الإدارة مع الكثير من المنافسات الشاملة بين الحلفاء الإقليميين.
الشرق الأوسط ورد فعل عنيف من السياسات الغربية
يقدم لنا التاريخ درسا واقعيا حول التورط الغربي في الشرق الأوسط. الدرس المستفاد من العقود الماضية من تدخل الولايات المتحدة هو أن الأميركيين لم يكن لديهم القدرة على حل المشاكل الأساسية التي تدفع بمنطقة قابلة للاحتراق، لا يهم كم في طريق من القوات والمال والجهد الفكري التي ترمى لأجل ذلك. إلا أن تحول التركيز من سياسة “الإصلاح” إلى سياسة الانسحاب وموجه “التوازنات” يأتي مع المخاطر الخاصة به.
من خلال التحالف مع الأنظمة الخليجية، والملاحظ أن معظمه مع المملكة العربية السعودية، ساهم الغرب في خلق عقيدة اسلامية محافظة وهابية ممولة تنتشر في جميع أنحاء المنطقة. وبذلك خلق الغرب في وقت لاحق الرغبة في خلق شخصية سيئة السمعة بإسم أسامة بن لادن، شخصية رعتها وكالة المخابرات المركزية، حيث دربت الشخص الذي حارب ضد الروس في أفغانستان. كان ذلك “جهاد ريغان” في العام 1980. “تقدير كبير لمآثر القاتل من مؤيدي اليوم لرمز الارهاب [أسامة] بن لادن ومعاونيه طالبان، ولحربهم المقدسة ضد” إمبراطورية الشر ، التي أسسها من قبل الرئيس الاميركي رونالد ريغان في 8 مارس 1985.” الولايات المتحدة شغلت البث التجريبي لراديو الحرية وراديو أوروبا الحرة، هذه المحطات التي بثت خطب الأصولية الإسلامية في جميع أنحاء آسيا الوسطى، في المقابل وبمفارقة كبيرة، شجبت “الثورة الإسلامية” التي أطاحت بموالين الولايات المتحدة وبشاه إيران في عام 1979.
ومن المفارقات خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، نظرية جورج دبليو بوش “محور الشر” الذي ترافق مع مشروع واشنطن لرعاية التحول الديمقراطي عن طريق تغيير النظام بقديم وصفة ساخنة للاضطرابات السياسية في منطقة غرب آسيا.
دعوة الشيطان للتدخل
تبين الأدلة أن التدخل العسكري الأمريكي حتى الآن، يزيد من الجهاديين – على سبيل المثال، كما هو موثق من قبل الصحفيين في اليمن – أو يخلق مجموعات جديدة أسوأ مثل تنظيم القاعدة في العراق، الذي تحول إلى داعش.
ثم أن الإسلاميين المتطرفين كانوا موجودين منذ عشرات السنين قبل 11/9، وما كان يشكل تهديدا ضئيل أو معدوما للولايات المتحدة البعيدة. في الواقع، خلال الحرب الباردة، غذت الولايات المتحدة الجهاد الاسلامي لمحاربة الشيوعية – على سبيل المثال، ساعدت الجاهديين في أفغانستان، التي تحولوا لاحقا إلى جماعة القاعدة.
العراق، ليس على وجه التحديد، لم يأوي تنظيم القاعدة، ولكنه وفر معسكرات تدريب وغير ذلك من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية التي تحارب حكومات تركيا وإيران، وكذلك الفصائل الفلسطينية المتشددة. في الواقع، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية في عام 2005 “مسألة صلة العراق بالإرهاب كانت أكثر إلحاحا من التقارير التي اشتبهت بإنتاج أسلحة الدمار الشامل (WMD) من قبل صدام حسين، والتي كان يخشى المسؤولون في إدارة بوش من انه قد تبادلها مع الإرهابيين الذين قد يشنون الهجمات المدمرة ضد الولايات المتحدة “. ومع ذلك، فإن اسلحة الدمار الشامل كانت السبب الرسمي المفترض الذي ركزت عليه الولايات المتحدة لإطلاق الغزو .
إنشاء داعش
عن غير قصد، أدت الرغبة في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط إلى تشكيل داعش. ظهرت اثنتين من الآثار الحاسمة في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق: أولها هو شرعية التمرد ضد الاحتلال الأمريكي للعراق. والثاني هو أن سيطرة الشيعة كنتيجة “للديمقراطية” ساعد داعش بتحولها إلى بؤرة لتجنيد السنة بالمقابل. وعلاوة على ذلك، فإن الأسلحة الثقيلة التي خلفها الجيش العراقي الفار، والكثير منها وفرته الولايات المتحدة، ساعد داعش في التحول إلى جيش شبه قادر على تعزيز قوته وزيادة مكاسبه. وأخيرا، الثورة الديمقراطية والحرب الأهلية الناتجة في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد الوحشي أدى إلى ظهور داعش القوة المتمردة الرئيسية والتي تسعى إلى تحويل المعارضة المعتدلة في ذلك الصراع إلى قوى متطرفة بشكل كامل.
قد سعت السياسة الأمريكية لتمتطي دوافع كل الأطراف وهذا أدى إلى أن تكون على وشك فقدان القدرة على صياغة الأحداث. تعارض الولايات المتحدة الآن البعض، أو على خلاف بطريقة أو بأخرى مع جميع الأطراف في المنطقة: مع مصر في مجال حقوق الإنسان؛ مع المملكة العربية السعودية في اليمن. مع كل الأطراف السورية ولكن على أهداف مختلفة ومتضاربة.
خطة واشنطن للاطاحة بالاسد
الولايات المتحدة تعلن تصميمها على إزالة الأسد ولكنها كانت غير راغبة أو غير قادرة على توليد ضغط فعال – سياسي أو عسكري – لتحقيق هذا الهدف. ولم تضع قدما الولايات المتحدة هيكل سياسي بديل ليحل محل الأسد في حال وجوب تحقيق رحيله بطريقة أو بأخرى. في واشنطن هناك العديد من الشخصيات، الذين يشيرون إلى أن هناك خللا في منطق سياسة رسمية تدعو للإطاحة بالأسد في حال أنها تتشارك معه العديد من ألد الأعداء، على رأسهم داعش وجهادي النصرة. وبعبارة أخرى، ليس هناك خطة.
سياسة التطارد المركزية المهندسة من قبل الغرب
في حين يساهم في خلق الحركات الإسلاموية، أجج الغرب الفجوة بين السنة والشيعة. كانت أيدي وكالة المخابرات المركزية وراء أكثر زعماء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفلسطيني علي حسن سلامة “الأمير الأحمر”، وصدام حسين، الذي كان كأحد أصول رأس مال وكالة المخابرات المركزية كما يتضح من رشيد الخالدي. تم التغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية. مثل تلك التي وقعت ضد الأكراد في حين تم احتضان الأكراد من قبل الغرب لضمان النفوذ – عامل زعزعة الاستقرار – في علاقتها مع الأنظمة الدكتاتور. الغرب، عبر حليفته إسرائيل، ساعد برعاية حماس، في حين كانت يدعم أيضا حكومة السلطة الفلسطينية من خلال تدريب قوات الأمن.
شهر العسل بين الغرب وإسرائيل
كان الغرب أيضا متورط بشكل كبير في إنشاء إسرائيل وظل يعبر عن هاجسه بشأن أمنها. أرادت أوروبا والولايات المتحدة موقعا في منطقة الشرق الأوسط وكانت إسرائيل مرشحا مثاليا. خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أدى إلى عدم استقرار أنظمة أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك أجبر العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة على التخلي عن حقوق الإنسان من أجل “محاربة إسرائيل”. إسرائيل، كما يخلص العديد من الخبراء، تعارض الديمقراطية في الشرق الأوسط وتدعم الطغاة. العداء لإسرائيل، على الرغم من أنه في كثير من الأحيان عداء خطابي، ساعد على خلق القومية العربية في ظل جمال عبد الناصر واستلزم الحكم الدكتاتوري في مصر وأعطى السبب لوجود حزب الله في لبنان. كما تم إنشاء “محور المقاومة” الذي يديره بشار الأسد بحجة معارضة إسرائيل. اتهمت الامم المتحدة اسرائيل دعمت عدم وجود الإصلاح والركود العام في المنطقة.
ويقول بعض المعلقون أن الدعم الغربي التقليدي للأنظمة السنية هي المشكلة، مما أدى إلى ما يسميه إلدار محمدوف “Shiaphobia”. إذ يقول “يجب على الغرب أن يرقى إلى المستوى السمعة التي نصب نفسه فيها بشكل خاص باعتباره حامي الحرية الدينية والتعددية في جميع أنحاء العالم.” واختتمت الايكونيمست تعليقها على الانقسام الشيعي السني: “العديد من حلفاء الغرب المحتملين أو الفعليين هم بالكاد أكثر ألذ شهية. بعض القوى الأقدر المناهضة لداعش هي الميليشيات الشيعية التي حاربت سابقا الجنود الأمريكيين وشنت في السابق حربا طائفية شرسة ضد السنة “.
أشار تقرير للأمم المتحدة حول التكامل العربي “الأطراف الغربية تنظر إلى المنطقة العربية باعتبارها مجالا حيويا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، ألا وهي الحفاظ على تدفق النفط بأسعار معقولة؛ الحفاظ على الأمن والتفوق العسكري لإسرائيل، ومحاربة الإرهاب “.
حكيم خطيب