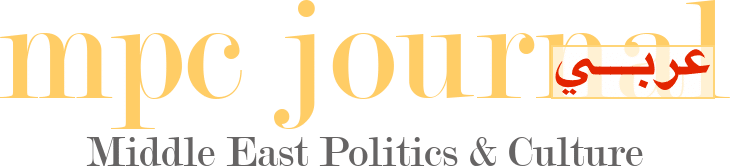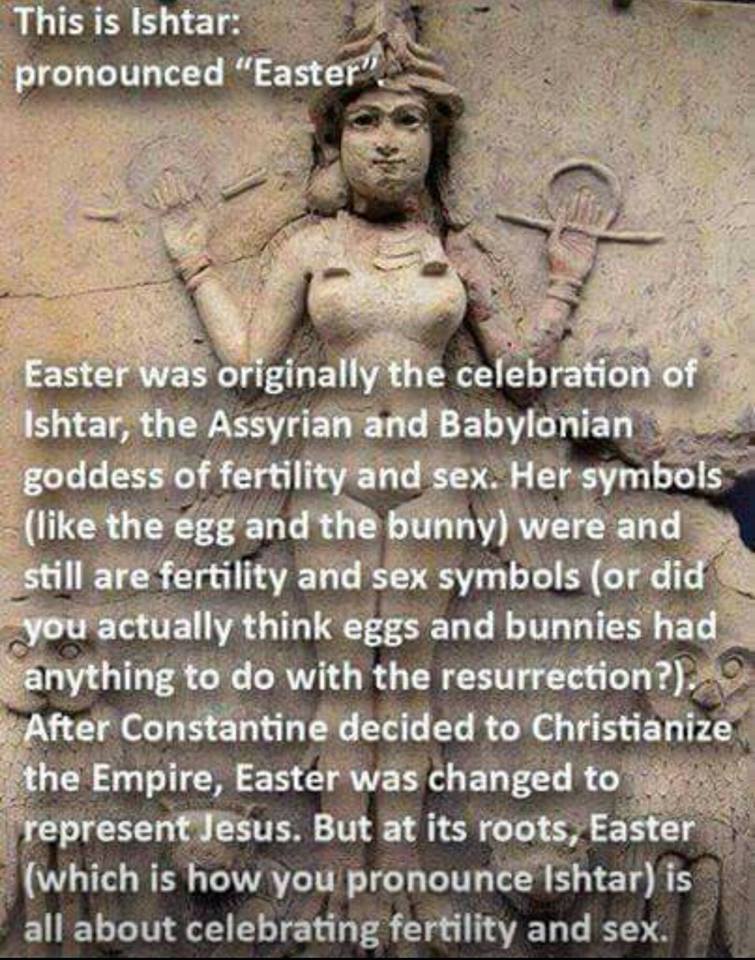ليست كلمة (مرآت) المستخدمة في العنوان خطأ املائياً، بل هي مفردة نُحتت هنا قصداً، لتكون صيغة جمعٍ لمفردة (المرأة)؛ تهرباً، أولاً، من استخدام كلمتي نساء ونسوة المشبعتين بأحكامٍ قيميةٍ مؤسِّسة لدونيةٍ المرآت، وتجنبا، ثانياً، لاستخدام كلمة المرأة في صيغة المفرد، لما قد توحي به من ماهوية ثابتة ناجزة تحاكي مخيالاً ذكورياً، بدل أن تحاكي واقعاً ينبض بالاختلاف. ومحقّةٌ سيمون دوبوفوار الفيلسوفة الفرنسية بقولها: (لا تولد المرأة منَّا، حين تولد، امرأة، إنَّما هي الثقافة في شموليتها من تشكِّل هذا المخلوق الذي ننعته بالأنثى). وثقافتنا الاجتماعية في العالم العربي، بوصفها المحدِّد الأول لهوية المرأة، هي ثقافةٌ ذكوريةٌ أبويةٌ، تشرعن وصايتها على المرآت، عبر توارثها لتصورٍ مخياليٍّ بدائيٍّ ينظر إليها على أنها كائنٌ قاصرٌ في طبيعتها المنقوصة المحكومة بوصايةٍ أبديةٍ عليها من قبل الرجل. وتُرسِّخ ذهنيةُ التقابل مابين ماهيةٍ فوقيةٍ اسمها الرجل وماهيةٍ دونيةٍ اسمها المرأة، حالةَ القصر المتبادلة، طالما أن كلا الطرفين محكومان بعلاقةٍ تغيب الندية عنها، ويتعطل التفكير فيها عن فهم حاجات كل طرفٍ، داخل علاقةٍ يُنظر إليها على أنها نتاج نواميس الطبيعة.
وهكذا تقودنا الصورة المشوهة عن المرآت الى تشوهاتنا نحن الرجال، ويظهر ذلك خصوصاً في فهمنا المشوه لأنفسنا، لكونه قائماً على الآلية ذاتها. ويفسر لنا ذلك ربما رومانسية الخطاب السياسي العربي حين يتحدث عن المرآت بصيغة: “المرأة هي أختنا الكريمة، وابنتنا الغالية، وأمنا الحنونة”. وكأنما من المستحيل الحديث عنها خارج علاقتها بنا. وبذلك يظهر خطابنا السياسي الرومانسي وكأنه في حالة من يرفض فطامه العاطفي! لماذا لا نستطيع أن نتكلم عن المرآت بوصفهن المواطنات اللواتي لا يختلفن في ذلك عنّنا نحن الرجال؟ ولماذا لا يتم المطالبة بحقوقهن في التعبير والعمل وفي التمثيل السياسي تماما كما نطالب بذلك لأنفسنا؟
تكفي نظرة بسيطة إلى حال المرأة في مجتمعاتنا، لندرك مدى الظلم الذي تعانيه، فنسبة الأمية بين الإناث في سوريا هي (26.1%)، وهي نسبة تزيد عن ضعف نسبة الأمية لدى الذكور (12.1%). وترتفع نسبة الأمية في صفوف الريفيات اللواتي يزيد عمرهن عن 25 سنة إلى 57%، وتنخفض لدى مثيلاتهن في المدن إلى 29%. ونسبة العمالة بين الإناث هي أقل بكثير من نسبتها لدى الذكور، بل وتكاد تكون معدومة في الكثير من المناطق (لا أرقام دقيقة ولا غير دقيقة، في هذا الخصوص). وبالإضافة إلى إقصائها من التعليم والعمالة، وهو الأمر الذي يعزّز من الوصاية عليها ويزيد من تبعيتها للرجل، فإن هناك جرائم ترتكب بحقها، منها على سبيل المثال، لا الحصر، حبسها في البيت الذي يتحول إلى معتقلٍ طوعيٍّ، بعد انعدام خيارات الخروج منه؛ ومنها أيضاً جريمة الاغتصاب الشرعية، عبر زيجاتٍ إكراهيةٍ ترتبط غالباً بما يسمى ﺑـ “التجيير” (وهو أن يحلف ابن العم أن ابنة عمه قد أصبحت له وعلى اسمه، فيمتنع الجميع عن طلب يدها، مما يضطر أهلها إلى تزويجها منه) أو ﺑـ “العضل”، حيث يمنع زواج المرآت إلا ممن اختاره الأب أو ولي الامر لهن، بغض النظر عن قبولهن أو عدم قبولهن له، وبعيداً عن التفكير في مدى مناسبته لهن شخصياً. والأخطر من هذا كله يتمثل بقتلهن المشرعن عبر جرائم العار أو العيب (الشرف)، وهي جرائم يرسّخها القانون، عبر تخفيف العقوبة، ويغض المجتمع – ممثّلاً في رجال فكره ورجال دينه – الطرف عنها حيناً، ويدعمها حيناً اخر.
لقد زعزعت الثورات العربية عموماً، والثورة السورية على وجه الخصوص، القيم التسلطية، ووضعت موضع تساؤل قيمنا الموروثة وتصوراتنا عن الذات وعن الآخر، كما وضعت الحرية في المرتبة الأولى بين قيمنا وأهدافنا. ولا يمكن أن نكون أحراراَ فعلياً، إلا حين نملك أن نختار؛ فسلب الانسان خياراته هو سلبه لحريته؛ والحرية نقيض للوصاية والفرض والإقصاء الذي نفرضه نحن الرجال على المرآت. للأسف، لم يأخذ سؤال المرأة (المرآت) في سوريا حقه، في ظل حرب القصف على الأسئلة وعلى حملة الاسئلة، ولكن ثمة إدراكٌ يقول: على المرآت أن تتحرر منّا نحن الرجال؛ وعلينا نحن أن نتحرر منهن ومعهن، كي نؤسس لعلاقةٍ نديةٍ متساويةٍ، اذ لا تساوٍ بدون نديةٍ، ضمن مواطنةٍ قائمةٍ على المشاركة لا الوصاية. الأسئلة، كما الثورات، تأتي رفضاً للإجابات القديمة المحكومة بالسقوط، وفتحاً لأفقٍ كان مسدوداً، وكذلك هو سؤال (المرأة) المرآت اليوم، في مجتمعنا السوري، يولد مع سقوط الإجابات الذكورية.
أحمد اليوسف، كاتب سوري دكتور في الفلسلفة.