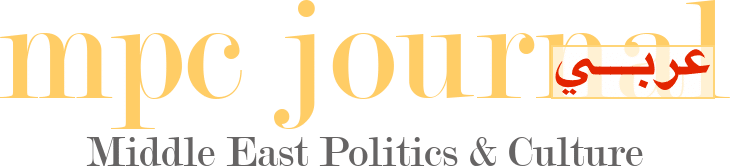كثيرا مانسمع أسئلة عن سبب قبول الناس باستغلالهم من قبل المستبدين؟ لماذا لا ينتفضون أو لا يصلحون أو لا يغيرون هذا الوضع القائم؟ ألا يودون العيش في ظل نظام ديمقراطي؟ وسمعنا الكثير من قبيل هذه التساؤالات. الواقع أن الناس يميلون أكثر لتمني نهاية الاستغلال خلاصهم من الاستبداد، لكنهم يفتقرون إلى التنظيم الجماعي الذي يمكنهم من ذلك. لذلك فإن الإجابة مرتبطة بالقضايا التنظيمية أكثر من ارتباطها بطموحات الشعب. الناس مهزمون تنظيمياً بفعل النخب الحاكمة. انتفاضهم ضد الاستبداد غالباً ما يخدم مصالح الديكتاتور عن مصالح الشعب.

[one_fourth_last padding=”0 10px 0 10px”][/one_fourth_last]
دعونا نأخذ مصر كنموذج، فبينما الناس كانوا خاضعين لاستبداد السلطة منذ الاستقلال، ومُسيطَر عليهم من قبل المؤسسة العسكرية والشرطة والنخب السياسية العليا (ما يمكن تسميته بالكتل الحاكمة). أمتثلت الجماهير لأكثر من 60 عاماً لأنها تفتقر التنظيم الجماعي للتخلص من هذه السيطرة. أي إشراك للناس في صناعة القرار كان يعني خسارة النظام لجزء من قوة سيطرته. بالتالي، فإن النظام بقيادة عبد الناصر، السادات، مبارك وأخيراً السيسي أبرزهم، قد خلق هياكل تضمن بقائه. وتمت عملية تنظيم وإعادة تنظيم شبكات العلاقات الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية بشكل قسري من خلال الإكراه والفرض، حتى ولو أن البعض ثاروا أو قاوموا (إلا أنه غالباً ما تكون هذه المقاومة غير قادرة على إحداث تغيير جوهري).
على كل حال، بحلول العام 2011، العجز الجماعي عن تغيير الوضع القائم في مصر تحول إلى عمل جماعي مما أدى إلى إحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق. وبينما هذه الحركات الدينماكية جدلية ومتداخلة، حصل توزيع للأدوار الوظيفية بين نخب مكونات الحكم في محاولة لإيجاد توازن مع التنظيم الجماعي للشعب. بعد سقوط مبارك، هذا التنظيم الجماعي جلب نخب جديدة للمشاركة في السلطة كأحزاب الأخوان المسلمين والسلفين. بسبب الصراع على السلطة بين القوى السياسية المتنازعة، كان من الضروري للنظام، تحديدا الجيش وقوى الشرطة، تفريق تنظيمات اللاعبين السياسيين المنافسين من أجل الاحتفاظ بالسلطة.

حركة الأخوان المسلمون كانت قد حُظرت في وقت لاحق في حين أن الأحزاب السلفية حيدت أو استدرجت بشكل عام. هذه العملية حصلت عن طريق الصراع تارة والتعاون تارة أخرى لتحقيق المصالح والأهداف المتضاربة بين القوى الفاعلة، آخذة شكل قوانين مؤسساتية وأعراف الحياة الاجتماعية. هذه التحولات باتجاه مأسسة الحياة الاجتماعية تمنح الكتل الحاكمة رخصة الإشراف عن كل شيء بما في ذلك من إعادة تنظيم لشبكة القوى للحفاظ على بقاء الشعب راضخا. وتصبح أياً من القوى المعارضة من خارج نطاق الحياة الاجتماعية المُمؤسسة غير شرعية ويمكن تفريقها بشكل قسري. هذا يكون أكثر وضوحاُ فيما لو أمعنا النظر في الحملة ضد الإخوان المسلمين واحتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري في عام 2013. في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدرت النخب الجديدة الانقلابية قانون التظاهر الجديد بموجب القانون رقم 107 في 24 نوفمبر 2013، والذي أعطى الحق لوزارة الداخلية في إلغاء أو تأجيل أو نقل أي مظاهرة فيما لو توافرت معلومات استخباراتية جدية عن أن المتظاهرون قد يخرقون القانون. هذا القانون كان تطبيقاً للإعلان الدستوري في 8 تموز 2013، بعد خمسة أيام فقط من إزاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
يمكننا أن نلاحظ تركيبتان من مكونات القوة، السلطة على الناس من خلال الفرض والإكراه، وهذا هو التنسيق. والسلطة من خلال الناس عبر مشاركة فهم جماعي، وذلك هو التعاون.
بسبب واقع عدم وجود برلمان منتخب في مصرمنذ العام 2013، تمتع السيسي بأمتياز تمرير القوانين على شكل مراسيم وفرض إرادته على الرغم من المقاومة الشعبية (بمنع القاعدة من المشاركة في الحكم). عملية اغتيال هشام بركات في انفجار سيارة مفخخة في 29 حزيران عام 2015، وهو رئيس النيابة العامة في مصر ومهندس الآلاف من الملاحقات القضائية بما في ذلك أحكام الإعدام المثيرة للجدل بحق أتباع جماعة الإخوان مسلمين، من الممكن أنها سهلت، والواقع أنها بالفعل سهلت، إزدياد صلاحيات السيسي السياسية في شبكات التواصل والتفاعل ومنحته مزيداً من التفوق التنظيمي على المصريين.

في جنازة بركات، وعد الرئيس السيسي بتعديل القوانين لجعلها تستجيب لتنفيذ العدالة. “في ظل هذه الظروف، المحاكم عديمة الفائدة وكذلك القوانين … أن يد العدالة مغلولة بالقوانين”، هذا ما قاله السيسي متوعداً بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد ضد من وصفهم بـ “الإرهابيين”. موطدا سلطته بشكل أسرع من أي ديكتاتور آخر في الشرق الأوسط لفرض قراراته على الشعب المصري والأراضي المصرية، السيسي حيد النظام القضائي فضلاً عن وسائل التواصل. ولضمان النجاح بذلك، سيطر السيسي على وسائل الإقناع (وسائل ذات الطابع المؤسساتي) – القانون ورجال الدين الموالين والحكومة ووسائل الإعلام – وعلى وسائل الإكراه وهي الجيش والشرطة وقوات الأمن.
وهكذا، فإن الناس أمتثلوا لأنهم لا يعرفون كيف يصنعون أو يمتلكون وسائل لتغيير شبكات القوى والمنظمات. بل هم جزء لا يتجزأ في هياكل السلطة التنظيمية، التي لا يسيطرون عليها. لقد تم تجاوزهم وإضعافهم من قبل من هم في أعلى هرم السلطة بحيث أنهم لا يستطيعون تحقيق تغيير جوهري. لا ينطبق هذا النمط فقط على مصر وإنما على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل. الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للسوريين ولا اليمنيين ولا الليبيين. الثورات في كثير من الأحيان لا تخدم تطلعات الشعب. ويبدو أنه من الصعب جداً تحويل عجز الناس إلى قدرة جماعية لفترة طويلة.
كما قال جورج أورويل في روايته ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون: “لا يؤسس المرء دكتاتورية من أجل حماية الثورة؛ لكنه يقوم بالثورة من أجل إقامة ديكتاتورية “.
[starbox id=”none”]