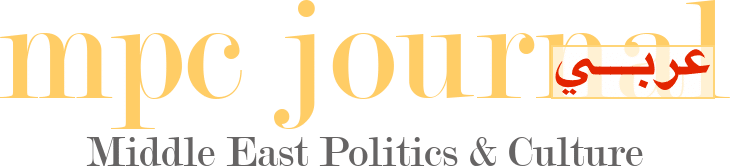بالنظر إلى السيناريو الحالي في الشرق الأوسط، يمكن للمرء أن يقبل منطقياً بالحجة القائلة إن الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط تتحمل مسؤوليتها على قدم المساواة السياسات الأنجلو أمريكية المكيافيلية في المنطقة والفشل المروع للحكومات الإسلامية والقيادات في الشرق الأوسط الشرق بالرد بعقلانية على هذه التحديات. ولكن هل هناك أي أبعاد وراء الدين؟
القومية والاضطراب
كانت مناطق غرب آسيا المعروفة باسم (الشرق الأوسط) وشمال افريقيا مكاناً للتوتر والصراع منذ نهاية القرن الـ 19. وقد برزت التوترات إبان تقسيم شمال أفريقيا وغرب أسيا بين القوى الأوروبية خلال فترة التوسع الاستعماري واتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا في عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى.
نتيجة التقسيم لم تأخذ بعين الاعتبار التنوع السكاني من أعراق وأديان ولغات ولا أي من الأبعاد الثقافية الأخرى، فرُسمت حدود الدول القومية وتأسست إمبريالية استعمارية إلزامية حتى منتصف القرن الـ 20.
في حين أن دور الغربي في المنطقة كان يتذبذب بين داعم أو مدمر للديكتاتوريات، ظل الاستقرار والأمن هما المقياس الثابت عند التدخل في المنطقة.
تشابكت هذه الإجراءات والعمليات المعقدة منذ الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، مع نشأت الدول القومية الحديثة الغير قادرة والغير راغبة في إقامة نظم سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل بشكل جيد. عمليات التحول الديمقراطي، الإجرائية والثقافية، تم تأجيلها. في الواقع كان هناك العديد من المسائل الحاضرة الملحة الأخرى غير الديمقراطية. الكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ، لاحظ ذلك بشكل صحيح في مصر “معظم الناس أكثر ما يقلقهم هو الحصول على الخبز لتناول الطعام. فقط بعض من المتعلمين فهموا كيف تعمل الديمقراطية “.
جاءت القومية لتحدد المواضيع بشكل فردي، فالذين عاشوا داخل حدود الدول القومية، على سبيل المثال، سوريون وعراقيون ومصريون الخ، إثنان من المفارقات طورا المشاعر القومية في المنطقة: الأول هو أن مفهوم القومية كان يستخدم بشكل متبادل للإشارة إلى العروبة، التي تستبعد قطاعات كبيرة من هذه المجتمعات مثل البربر في بلدان شمال أفريقيا والأكراد في سوريا والعراق.
الحدود المرسومة حديثا لم تخلق فقط حدود بين الأغلبيات، ولكن أيضا بين الأقليات الدينية. الدروز قُسموا بين سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل (سابقا فلسطين)، والأكراد بين سوريا والعراق وتركيا وإيران والأرمن بشكل أكثر بين دول قومية.
وكانت حتى الأسماء الرسمية للدول القومية الاستبدادية محلاً للجدل: جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية الخ، لقد فشلت الدولة القومية في الاعتراف بالتنوع الثقافي داخل حدودها، تماماً كما فعلت القوى الاستعمارية من قبلها، وعلى حد تعبير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي: “لقد ولى زمن القومية العربية والوحدة إلى الأبد. هذه الأفكار، التي كانت عبء على الجماهير، ليست سوى عملة لا قيمة لها “.
والثاني هو أن الدول القومية لم تقدم سوى القليل جدا لخدمة المجال الثقافي في المنطقة وبالمقابل قدمت الكثير لخدمة الأشكال الديكتاتورية الفكرية. في حين أن الدول القومية، للأسف لا تزال تفتقر إلى الرؤية والمشاركة والمساهمات الجدية لمواطنيها، وقد شل التضخم السكاني السريع في المنطقة المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تكافح بالفعل. في عام 2014، كانت المنطقة موطناً لما يقرب 2% من سكان العالم.
التركيز على مفاهيم القومية، وعدم القدرة على الاستجابة لتناقضات الحياة الحقيقية مهد الطريق لازدهار الأيديولوجيات الإسلامية. وبعبارة أخرى، فإن الاستجابة الناقصة والغير الكافية لاحتياجات الشعوب زادت من الأطر الجامدة في الفكر الأيديولوجي، الطروح الإسلامية المناقضة للقومية كانت في الواقع تتسابق للوصول إلى السلطة. وتدريجياً تم الخلط بين مفهومي العروبة والاسلام، اليوم أصبح من الصعب التمييز بين القومية والإسلام، لذلك يمكن للمرء القول ببساطة الإسلاميين القوميين أوالقوميين الإسلاميين دون أن يشكل ذلك فرقاً.
آزمة الهوية
منطقة المشرق، وهي كلمة عربية تعني مكان شروق الشمس، تعتبر مهد الحضارات الإنسانية القديمة ومهد الديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام. ومع ذلك، فإن مساهماتها الأخيرة في التنمية البشرية يمكن اعتبارها، بكل ثقة، الحد الأدنى بالمقارنة مع تلك المساهمة الغربية منذ عصر التنوير. هذا هو البعد الزمني في آزمة الهوية.
شهدت منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا خلال فترة الحرب الباردة أفضل حالاتها. في حين كانت تميل بعض الأنظمة للتحالف، على الرغم من أن ذلك كان في بعض الأحيان بشكل متقطع، مع الولايات المتحدة، كانت تميل بعض الانظمة الأخرة للتحالف مع الاتحاد السوفييتي. تميزت فترة ما بعد الاستعمار “استخراج النفط” بشكل ملحوظ بالحسابات الجيوسياسية في المنطقة. قضية تأمين تدفق النفط والغاز دون انقطاع وبأسعار مقبولة للولايات المتحدة وحلفائها لا تزال تشكل الدعامة السياسية الأساسية للتدخل الأجنبي المباشر في المنطقة. المشرق، وبعبارة أخرى، يعاني من العديد من النزاعات السياسية ومن هيمنة القوى الأجنبية بشكل كبير. التجزئة في المنطقة ليست فقط لغويا وعرقيا ودينيا، ولكن أيضا أيديولوجيا: القومية، البعثية، الاشتراكية، الشيوعية، الليبرالية والإسلامية. هذا هو البعد الفلسفي للآزمة هوية.
تنشأ الآزمة عندما يكون هناك صراع بين طبقات متعددة تحدد الهوية التي يجب أن تتوافق بين فهم الذات والواقع الفعلي. على سبيل المثال الشعور بالفخر بكونك تحمل الجنسية المصرية أو السورية يصتطدم مع واقع قاس جداً هو أنه لا جوازات السفر المصرية ولا السورية في مركز لائق مقارنة مع وثائق سفر أخرى من العالم كله تقريبا. هذا هو البعد النفسي للأزمة هوية.
الأفراد في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لا يزالون يواجهون العديد من الإشكاليات لتعريف أنفسهم، وخاصة في الإجابة عن سؤالين هامين: من هم بصفة جماعية أو فردية؟ وأين هم في العالم اليوم؟ تأمل جاد في هذه القضايا لديه القدرة على تحقيق نتيجتين حاسمتين: خفض أشكال الأيديولوجية الجامدة الفكر وازدياد الوعي الذاتي.
الأيديولوجيات مع نكهة إسلامية
خلال سبعينات القرن الماضي، الحركات الإسلامية والحركات الأيديولوجية المتزمتة ذات النكهة الإسلامية، تعاظمت بفعل الهزائم العسكرية المتلاحقة التي منيت بها الأنظمة القومية على يد إسرائيل. لقد ظهرت هذه الحركات كتحدي للنموذج العلماني الغربي في الحكم والتحديث من جهة، وفي العودة إلى المراجع الإسلامية “يحكم بما أنزل الله في القرآن” من جهة أخرى. هذا هو البعد النفسي الآخر من أزمة هوية، بل هو عملية التحديث نفسها. نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة آية الله الخميني مثل دعم سياسي وايديولوجي للحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة، مثل جماعة الإخوان مسلمين في سوريا ومصر والأردن ودول أخرى، وبعد ذلك إلى الحركات الأكثر تطرفا كجماعات مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، زادت الولايات المتحدة من قدراتها العسكرية في شبه الجزيرة العربية خلال حرب الخليج 1990-1991. وقد أدى ذلك إلى ازدياد المشاعر المعادية للولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي خلق ظروفاً مثالية للمتشددين الاسلاميين، بما في ذلك الحركات التابعة لتنظيم القاعدة، لاكتساب الأرض من الشعوب المتعبة.
خلاصة القول، هناك عدة أسباب وراء استمرار الاضطرابات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتقوم بعض منها على التدخل الخارجي، وبعضها الآخر يكمن في قلب المنطقة. لا بد من تقديم روايات جديدة وخلق ذاكرة جماعية، يجب تفعيل ذلك بشكل مكثف وعلى نطاق واسع من أجل الوصول إلى مستوى ثابت من التهدئة بين جميع الأطراف المتنازعة.
الأفراد في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لا يزالون يواجهون العديد من الإشكاليات لتعريف أنفسهم، وخاصة في الإجابة عن سؤالين هامين: من هم بصفة جماعية أو فردية؟ وأين هم في العالم اليوم؟ تأمل جاد في هذه القضايا لديه القدرة على تحقيق نتيجتين حاسمتين: خفض أشكال الأيديولوجية الجامدة الفكر وازدياد الوعي الذاتي.
حكيم خطيب