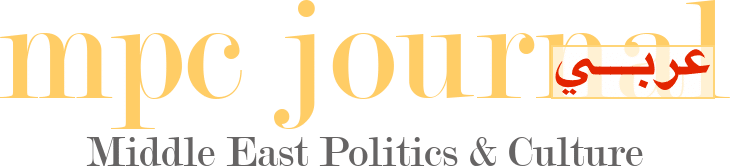وصل التوتر بين القيادة الدينية ممثلة في شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب والقيادة السياسية ممثلة في رئاسة الجمهورية حداً لم يعد من الممكن إخفاؤه، وتحول الخلاف المكتوم إلى خلاف معلن، مع تعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إثارته في خطاباته العامة، والتي كان أخرها قضية الطلاق الشفهي، ووصل الأمر إلى قول السيسي للطيب “تعبتني يا فضيلة الإمام”. وقد رفضت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر دعوة السيسي بضرورة توثيق الطلاق حتى يتم الاعتراف به، ومن مظاهر الخلاف أيضاً تطرق شيخ الأزهر في كلمة له في مؤتمر عن تجديد الخطاب الديني في نوفمبر 2015، إلى قضية الديمقراطية وحقوق الانسان.
وبدلاً من التوقف عند بعض القضايا الخلافية التي تركز عليها وسائل الإعلام، فإن الفهم الأعمق والأشمل لأبعاد الخلاف يقتضي التطرق إلى عدد من المحددات الخالقة للتوتر، والتي نحددها بثلاثة عوامل أساسية.
الإخلال بمشروطية الدعم
جرت العادة على النظر إلى مشهد قيام السيسي بإلقاء بيانه الشهير يوم 3 يوليو، وهو محاط بمختلف الرموز الوطنية، باعتبارها لحظة عاكسة لتوافق شامل بين الأطراف المشاركة في المشهد السياسي المصري. كان وجود الطيب في هذا المشهد يكتسب أهمية مضاعفة، نظراً لمكانته الدينية، في لحظة المواجهة مع جماعة الاخوان المسلمين، التي تستخدم الدين كأساس للحشد والتعبئة وبناء الشرعية؛ وباعتباره إعلان صريح عن انحيازات شيخ الأزهر في هذا الصراع، ولكن ثمة ما يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.
قام أحمد الطيب بإلقاء بيان إضافي، أكد فيه أن مشاركة الأزهر في هذا المشهد غرضها الوحيد منع الضرر الأكبر، المتمثل في إسالة الدماء، والقبول بالضرر الأصغر، المتمثل في عزل الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات مبكرة. هذا البيان كان يعتبر بمثابة مشروطية خاصة بالأزهر، لتقديم الدعم للأوضاع الجديدة، ولإبراء الذمة في حالة الخروج على الشروط المتضمنة في البيان. ويدعم هذا التفسير اللهجة التصعيدية في البيانات التالية، مع قيام النظام الجديد بانتهاج سلوك مخالف لما تم التوافق عليه، وصولاً لأحداث فض رابعة، والتي كانت لحظة فِراق علنية بين الأزهر والنظام.
في الخامس من يوليو 2013 ألقى الطيب بياناً صوتياً إضافياً، حرص فيه على التأكيد على أن “الدين أو الوطنية براء من أي دم يُسْفَك”، وحذر من انزلاق القوات المسلحة إلى ممارسات تحيد بها عن وظيفتها الرئيسية؛ وفي بيان صوتي حول مجزرة الحرس الجمهوري، طالب شيخ الازهر بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث، وأن يتم الإعلان عن تفاصيل محددة للفترة الانتقالية، وإطلاق سراح المعتقلين. وتكرر الصدام في بيان الطيب عقب وقوع الفض لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
الصراع حول من له السلطة العليا على الدين
كان النظام الجديد حريص على إفقاد الإخوان ورقة قوتهم الرئيسية، وهي ادعاء المشروعية الدينية لتوجهاتهم السياسية؛ لذا فإن مواجهة الدعاية الإخوانية كانت تتطلب دعاية مضادة من النظام، بحيث تمكنه من الصمود في وجه المزايدات الدينية داخلياً، والترويج لشرعيته خارجياً، في محاربة التطرف الديني. في هذا الإطار كانت سردية النظام في بناء شرعيته محلياً ودولياً تعتمد في جانب منها على رفع لافتة تجديد الخطاب الديني.
أسس هذا المسعى لخلاف آخر بين الأزهر والنظام؛ وهنا يتجاوز التحليل المستوى الشخصي للقيادتين الدينية والسياسية، لنتحدث عن صراع مصالح مؤسسية، وهو ما يستوجب العودة قليلاً إلى الوراء.
بعد ثورة 25 يناير 2011، أفضى تصاعد دور التيارات الدينية، إلى تزايد الطلب على دور سياسي وإعلامي أكبر للأزهر، لموازنة حضور هذه التيارات في المجال العام، وكان هذا الدور مدعوم من قبل الدولة وقطاع من النخب المدنية والمثقفين، الذين تم إشراك بعضهم في الوثائق التي أصدرها الأزهر بعض الثورة، وبالأخص الوثائق الأربعة حول مستقبل مصر، ونبذ العنف، والحريات، وحقوق المرأة، وكان موقف الأزهر خلالها أقرب للأصوات المعارضة للإسلاميين.
في هذا السياق، تمكن الأزهر من ترجمة هذا الدور في صورة مكاسب مؤسسية في المادة 4 من دستور 2012، ثم المادة 7 في دستور 2013، حيث تمتع بغطاء دستوري لاستقلاليته عن السلطة السياسية، فأصبح الأزهر هو الجهة المخولة بتفسير الدين، وأصبح شيخه محصناً من العزل، ويتم اختياره بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء، فضلاً عن ضمان الدعم المالي له. أعطت هذه المزايا الدستورية قوة مؤسسية للأزهر في علاقته بالسلطة السياسية أياً كانت، في ظل بيئة سياسية تشهد انقساماً داخل مؤسسات الدولة نفسها. في مقابل هذه المكاسب، قام السيسي بزيادة الضغوط العلنية على الأزهر في قضية تجديد الخطاب الديني وتعديل المناهج، إلا لأن الأزهر لم يتبنى بصورة تامة رؤية النظام لفكرة تجديد الخطاب الديني.
كان البديل بالنسبة للنظام هو دعم بعض الرموز الدينية الموالية له والمحسوبة على الأزهر، حتى وإن لم تكن تشغل موقعاً قيادياً داخله؛ وهنا كان علي جمعة على رأس هذا البدائل، جمعة أكثر من مجرد عالم دين، حيث يشرف على عمل العديد من المؤسسات الخيرية واسعة النشاط، وأشهرها مصر الخير وبنك الطعام؛ كما أنه تسلم إدارة بعض المؤسسات الخيرية الإخوانية التي صادرتها السلطة، مثل الجمعية الطبية الإسلامية. وعقب الإطاحة بالإخوان، قام جمعة بتأسيس جبهة “مصر بلدي” وتولي رئاستها الشرفية، حيث هدفت الجبهة إلى توفير ظهير سياسي للسيسي، وتجهيز مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية؛ كما شارك جمعة في حملة “كمل جميلك” لدفع السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.
هذا الصعود السريع لدور على جمعة لم يتمكن أحد من كبحه إلا شيخ الأزهر، فقام الطيب بالاجتماع بهيئة كبار العلماء، واستصدار قرار بحظر ممارسة النشاط السياسي على أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها جمعة نفسه، مما أجبره على الاستقالة من جمعية مصر بلدي. تم تعويض التراجع النسبي لدور علي جمعة بتزايد دور تلميذه أسامة الأزهري، الذي تم تعيينه مستشاراً للسيسي، فضلاً عن قيام الرئيس بتعيينه عضواً في البرلمان.
وبشكل عام أصبح هناك انقسام قائم بين مؤسسة الأزهر، وبين بعض الرموز الدينية المحسوبة على النظام، ومعها وزير الأوقاف ودار الإفتاء؛ وهذه الأطراف الداعمة للنظام لم يتوقف الرئيس عن استخدامها في صراعه المستمر مع الأزهر، وهو ما خلق عدد من الأزمات بين الأوقاف والأزهر، فضلاً عن بعض الحملات الإعلامية الموجهة ضده، والتي شارك فيها أسامة الأزهري نفسه.
مناوئة القوى التقليدية
تمثل القوى التقليدية أحد المكونات الرئيسية للقاعدة الاجتماعية للسلطة في مصر؛ وتمر تلك العلاقة من خلال المؤسسات الرسمية؛ ولا يشذ الأزهر عن تلك القاعدة، حيث التغلغل العميق في المجتمعات المحلية في مختلف أرجاء مصر عبر الآلاف من المعاهد الأزهرية، والعديد من فروع جامعة الأزهر، وكذلك الدور الاجتماعي الكبير الذي كان يمارسه الأزهر، من خلال الأوقاف التابعة له، قبل أن يتم فصلها عنه خلال الحقبة الناصرية. ومن ثم يمثل الأزهر قلعة للقوى الاجتماعية الممثلة للفكر المحافظ والتقليدي.
تشير علاقة السيسي بالقوى الاجتماعية التقليدية إلى وجود خصومة متبادلة، فمنذ بداية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو يعلن دائماً بشكل صريح عدائه لقواعد الحزب الوطني، حيث كرر قبيل انتخابه أنه “لا يحمل جميل لأحد سوى لله والمصريين”، وأنه لا عودة لرموز دولة مبارك.
ونتيجة لهذا العداء، شهدت الانتخابات الرئاسية ما يشبه العقاب الجماعي من قبل أغلب القوى التقليدية للسيسي، من خلال المقاطعة الكبيرة للتصويت، والتي انعكست في خواء اللجان الانتخابية من المصوتين. ولم تكن عائلة شيخ الأزهر بعيدة عن تلك الواقعة، وهو ما أشار إليه وقتها الإعلامي توفيق عكاشة، حين تناول بشكل مباشر تقاعس عائلة شيخ الأزهر عن دعم السيسي في الانتخابات.
خلاصة القول إن الخلاف بين الأزهر والنظام القائم يتجاوز القضايا الآنية التي يتم إثارتها في وسائل الاعلام مؤخراً، فكل هذه القضايا الخلافية تظل مجرد تجليات عاكسة لخلاف أعمق، فالخلاف الحالي بين الطيب والسيسي ليس خلافاً مستجداً، وأن لحظة الإطاحة بالإخوان لم تكن لحظة تحالف بين الأزهر والنظام الجديد، بقدر ما كانت لحظة تأسيسية لخلاف عميق، في ضوء تباين التصورات بين القيادة الدينية والرجل الأقوى في النظام الناشئ، حول كيفية إدارة شئون الدولة بعد الإطاحة بالاخوان المسلمين.
بلال عبد الله باحث مصري متخصص في الشئون الداخلية والسياسة الخارجية المصرية، يكتب حالياً رسالة الماجستير الخاصة به عن القبلية في ليبيا.
اللغة الأنكليزية على موقعنا هنا